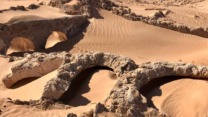لم تبقَ المرأة الجزائرية خلال الثورة التحريرية تتفرج على أخيها الرجل، بل كانت إلى جانب إخوانها الثوار.. المجاهدة، المكافحة، الفدائية والممرضة.. تعرضت مثلهم للاعتقال، التعذيب،
التنكيل والاستشهاد.. فقد كانت الجميلات الجزائريات عنوان التحدي والصمود، ومطلع قصائد عدد من الشعراء الذين بهرتهم بطولة حفيدات لالة فاطمة نسومر.
جزائريات تزينت ملامحهن بالبطولة

التاريخ يحكم ولا يجامل أحدا وهو إما يحكم للبشر أو عليهم، والمرأة الجزائرية ممن حكم لهم التاريخ وليس عليهم، ونقش أسماء المجاهدات الجزائريات بأحرف من ذهب.
فثورة نوفمبر أزالت الفرق الموجود بين الرجل والمرأة تجاه الواجب المقدس المتمثل في تحرير الوطن، فأطلقت المرأة الجزائرية العنان للقوى الكامنة فيها، والتفت حول جبهة وجيش التحرير الوطني، وقامت بأصعب المسؤوليات وأخطر العمليات.. وقدمت الفتاة والمرأة الجزائرية الزاد والوقود للثورة.
وهذا ما أشاد به مؤتمر الصومام (20 أوت 1956) في مقررته “وإننا لنحيّ بإعجاب وتقدير ذلك المثل الباهر الذي تضربه في الشجاعة الثورية الفتيات والنساء الزوجات والأمهات، ذلك المثل الذي تضربه جميع أخواتنا المجاهدات اللائي يشاركن بنشاط كبير- وبالسلاح أحيانا- في الكفاح المقدس في سبيل تحرير الوطن “.
كما جاء في توصيات مؤتمر الصومام بخصوص الحركة النسائية ما يلي:
“الحركة النسائية ومهمتها إذكاء روح الحماس في صفوف الجيش وأعمال الاتصال والمخابرات وتهيئة الملاجئ وإسعاف عائلات الشهداء والمعتقلين”.
وكما هو معلوم أن الجزائرية لم تنتظر نوفمبر 1954 حتى تقاوم بل ساهمت مساهمة إيجابية فعالة في الثورات الكثيرة التي توالت وتجددت في الجزائر منذ أن وطأت أقدام المستعمر أرضها الطاهرة سنة 1830.
الروح والولد فداء للوطن

لعبت المرأة الجزائرية دورا رياديا من خلال مشاركتها الفعالة في الثورة التحريرية سواء في الأرياف أو المدن على حدّ سواء، فالمرأة الريفية استطاعت أن تكون عنصرا فعالا في كسر الحصار الذي حاول الجيش الاستعماري ضربه على المجاهدين، فكانت مساهمتها قوية في تقديم الخدمات الكبيرة التي كانت الثورة بأمس الحاجة إليها، وتحملت أعباء الثورة في الجبال والقرى والمداشر، كما قامت أختها في المدينة هي الأخرى بواجبها الوطني وكانت السند القوي للمجاهدين من فدائيين ومسبلين داخل المدن، حيث تكثر أجهزة القمع البوليسي والمراقبة المستمرة على كل ما هو متحرك داخل المدن، فحلّت محلّ أخيها الفدائي في العديد من المهام المعقدة والخطيرة.
وأدركت الجزائرية الحرة المناضلة مسؤوليتها تجاه دينها ووطنها، فوقفت بجانب الرجل داخل صفوف الثورة المسلحة بإيمان قوي وإرادة صلبة تعزز الصفوف وتقوم بالعمليات الرائدة.
وأوكلت لها أعمال تتجاوز طبيعتها البيولوجية، فقد مارست أعمالا كثيرة في صفوف جيش التحرير بعدما تدربت على استعمال السلاح، وعلى علاج المرضى والجرحى، كما اهتمت أيضا بشؤون الإدارة بمساعدة كاتب القيادة، وعملت بالكتابة على الآلة الراقنة لإعداد المنشورات والأوراق والدعايات، وإيصال الاشتراكات أو كتابة التقارير والقوانين العسكرية، أما المجاهدة المثقفة فكانت تتلقى دروسا في التوعية السياسية.
أما الفدائية في المدن فكانت تنفذ عملياتها وسط السكان بدون أن ترتدي الزي العسكري، وكانت الفدائيات يتصفن بالشجاعة، طول النفس، الصبر الطويل ورباطة الجأش، حيث تضعن القنابل في المقاهي ومراكز تجمع العدو وكل ذلك في وضح النهار ووسط الناس.
سجون قمعية خاصة بالمرأة
لم تكن السجون في الجزائر وخارجها مخصصة للرجال فقط، إنما شملت النساء كذلك، ومع ذلك فإن السجون الخاصة بالمرأة الجزائرية خطيرة إلى درجة رهيبة من الصعب على المرأة احتمال أعمال زبانيتها، والملاحظ أن عدد السجينات الجزائريات اللواتي تم اعتقالهن وصل إلى نسبة 16 بالمائة عام 1956 لتبقى هذه النسبة في الارتفاع.
تستقبل خبر استشهاد أبنائها بالزغاريد
من المجاهدات من تعمل في جهاز الاتصال بين العاصمة والجبل، بين المجاهدين وأهلهم أو أصحابهم في النضال، فكانت الرسائل تروح وتجيء في سرية وبطرق غير مشكوكة، كما أن النساء اللواتي كان الجيش الفرنسي يستخدمهن لغسل ملابس الجنود، كانت الجزائرية تستولي على كثير منها، وترسلها لجيش التحرير، وتهرّب المؤونة والذخيرة باستمرار، إضافة إلى تدبير هروب الشبان وانضمامهم لصفوف جيش التحرير.
كما ساهمت المناضلة الجزائرية بكل جوارحها ومشاعرها، خاصة عندما تودع زوجها وفلذات أكبادها إلى ساحة الفداء من أجل القضية الوطنية المقدسة، كما تستقبل خبر استشهادهم بالزغاريد والدموع، وفي كل ذلك نجدها تتحلى بالجِلد والشجاعة، بل تتحمل ما ينجر عنه من عمليات الانتقام عندما يعلم المستعمر بأن هذا البيت قد خرج منه مجاهدون، وهذه زوجة أو بنت أو أخت أو أم… فسوف يصب عليها كل أنواع الانتقام من تعذيب واستنطاق ونيل من الشرف، وفي هذا الصدد تقول المجاهدة مزياني مداني لويزة في حديثها للصحافة:
“… عشت هذه التجربة في بيتنا في شهر جوان 1958 وبالذات في 15 منه ونحن نستعد لوداع أخي عمر وهو الأخ الرابع الذي يغادر البيت إلى الجبل.. إلى ساحة الفداء.. بعد خروجه من السجن في 08/06/1958 وبعد أن قضى فيه مدة عامين كاملين، فيا لها من ليلة قضيناها نعد فيها الساعات، وصباح نحصي فيه اللحظات… وقد انتهت ووقفنا نودع آخر الإخوة إلى ميدان القتال ضد المستعمر… كانت لحظات حاسمة… تطغى فيها العاطفة… وتنتصر فيها التضحية، والإيمان بالواجب الوطني… كيف لا؟!! والأم صابرة صامدة.. أم أربعة مجاهدين صناديد… تتحمّل هذا الموقف بشجاعة بالغة… وتتغلب على مشاعر الأمومة بجلد وتحدي… ولم تدمع عيناها إلا حينما قبّلها هذا الابن مودعا وهو يقول كوني صبورة يا أماه”.
لمياء بن دعاس